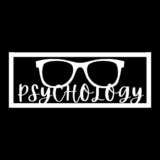العلاقات الأسرية وتأثيرها على الصحة النفسية

تُعَدّ الأسرة الركيزة الأساسية في تشكيل هوية الإنسان وبناء توازنه النفسي والاجتماعي. فهي ليست مجرد إطار للعيش المشترك، بل منظومة معقدة من التفاعلات العاطفية والسلوكية والقيمية التي تؤثر مباشرة على النمو النفسي منذ السنوات الأولى للحياة. إن جودة العلاقات الأسرية—سواء اتسمت بالدعم والحب أو بالصراع والإهمال—تترك آثارًا طويلة الأمد على الصحة النفسية، قد تتجلى في صورة الثقة بالنفس، القدرة على مواجهة الضغوط، أو على العكس، في اضطرابات القلق والاكتئاب.
تشير الأدبيات النفسية الحديثة إلى أن الأسرة تمثل “عامل حماية” أو “عامل خطر“، يجعلها من أهم المحددات للصحة النفسية على امتداد مراحل العمر، من الطفولة وحتى الشيخوخة. وفي زمن تتزايد فيه الضغوط المجتمعية والتحولات السريعة، تصبح دراسة أثر الروابط الأسرية على الصحة النفسية ضرورة لفهم كيفية بناء أفراد أكثر استقرارًا ومجتمعات أكثر تماسكًا.
دور الأسرة في الصحة النفسية منذ الطفولة
1- مرحلة الطفولة المبكرة (0 – 6 سنوات):
- التعلق الآمن: عندما يتلقى الطفل استجابة سريعة وحانية من الأم أو الأب عند بكائه أو حاجته، يترسخ لديه شعور بالأمان الداخلي، وهو ما يشكل أساس بناء الثقة بالنفس لاحقًا.
- النمذجة السلوكية: الطفل يتعلم أولاً من خلال الملاحظة والتقليد؛ إذا رأى والديه يعالجان الغضب بهدوء، فسيتعلم ضبط انفعالاته، أما إذا كان الجو مليئًا بالصراخ والعنف، فسيميل إلى السلوك العدواني.
- الحرمان والإهمال: غياب الرعاية أو الاحتضان العاطفي يؤدي إلى القلق المزمن، ضعف القدرة على تكوين صداقات لاحقًا، واضطرابات في الثقة بالآخرين.
- التحفيز المعرفي والعاطفي: الأسر التي توفر بيئة غنية بالحديث، اللعب، والقصص ترفع مستوى الذكاء العاطفي والمعرفي للأطفال، مما يقيهم من اضطرابات التعلم وضعف المهارات الاجتماعية.
2- مرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة (7 – 12 سنة):
- بناء الهوية المدرسية والاجتماعية: الدعم الأسري في هذه المرحلة يرفع التحصيل الأكاديمي، بينما غياب المتابعة قد يؤدي إلى صعوبات التعلم والشعور بالفشل.
- تنمية الاستقلالية: السماح للطفل باتخاذ قرارات بسيطة (اختيار الملابس، الألعاب) يعزز ثقته بنفسه، في حين أن السيطرة المفرطة تؤدي إلى الخوف من الخطأ والشعور بالعجز.
- العقاب مقابل التشجيع: العقاب البدني أو اللفظي يزرع مشاعر الخوف والذنب، بينما التشجيع والاحتواء يعززان السلوك الإيجابي وتقدير الذات.
- التوازن العاطفي: وجود تواصل أسري مستقر يقلل من القلق والاكتئاب الطفولي، بينما النزاعات الزوجية قد تنعكس على الطفل بصعوبات نوم أو نوبات غضب.
3- مرحلة المراهقة (13 – 18 سنة):
- الحوار المفتوح: القدرة على مناقشة القضايا الحساسة (الدين، العلاقات، المستقبل) مع الأبوين تحمي المراهق من اللجوء إلى مصادر غير موثوقة (رفاق السوء، الإنترنت).
- الهوية والانتماء: الأسرة توفر قاعدة آمنة يخوض منها المراهق تجربة البحث عن ذاته، بينما غياب الدعم يدفعه إلى الانجراف وراء هويات بديلة أو سلوكيات منحرفة.
- التوازن بين الحرية والرقابة: الإفراط في الرقابة يولد التمرد، في حين أن الحرية غير المنضبطة قد تؤدي إلى الإدمان والانحرافات السلوكية. الأسر الناجحة هي التي تمارس “الرقابة المرنة”.
- النزاعات الأسرية: الخلافات المستمرة بين الأبوين أو مع الأبناء تزيد من التوتر النفسي، وتدفع المراهق للبحث عن بدائل خارج الأسرة كالانخراط في جماعات خطرة أو العزلة الرقمية.
4- مرحلة البلوغ والشباب (19 – 30 سنة):
- الدعم الأسري للإنجازات: الدعم النفسي من الأسرة يعزز فرص النجاح الأكاديمي والمهني، إذ يشعر الفرد أن إنجازاته لها قيمة عند أقرب الناس إليه.
- التأثير على العلاقات العاطفية: الشباب الذين نشأوا في أسر داعمة يميلون لبناء علاقات عاطفية مستقرة، بينما الذين نشأوا في بيئات مضطربة يعانون من صعوبة الالتزام أو الخوف من الارتباط.
- الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية: الأسرة التي تشجع أبناءها على تحمل المسؤولية تدريجيًا تساعدهم على التكيف مع ضغوط الحياة، بينما الأسر المتسلطة تخلق شبابًا معتمدين نفسيًا واقتصاديًا.
- خطر الأسر المفككة: التفكك الأسري في هذه المرحلة يزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب، العزلة الاجتماعية، واضطرابات القلق، خصوصًا مع مواجهة تحديات الاستقلال والعمل.
5- مرحلة الرشد المتأخر والشيخوخة:
- دور الأبناء تجاه الوالدين: في المراحل المتقدمة من العمر، تصبح صحة الوالدين النفسية مرتبطة بشكل وثيق بدعم الأبناء لهم. الشعور بالتقدير والمكانة داخل الأسرة يحمي كبار السن من العزلة والاكتئاب.
- الحفاظ على الروابط: التواصل المستمر من الأبناء والأحفاد يعزز مشاعر الانتماء، ويمنع الوحدة التي تعد أحد أخطر مسببات الاكتئاب عند المسنين.
- الإهمال الأسري: غياب الرعاية في هذه المرحلة قد يؤدي إلى فقدان المعنى والشعور بعدم الجدوى، وهو ما يرفع معدلات الاضطرابات النفسية وحتى الأفكار الانتحارية.
الأثر الإيجابي للعلاقات الأسرية السليمة
1- تعزيز الثقة بالنفس
- التشجيع المستمر: الأسرة التي تركز على نقاط القوة وتدعم المحاولات، حتى في حال الفشل، تساعد على بناء تقدير الذات.
- الاعتراف بالإنجازات: عندما يُثني الأهل على إنجازات صغيرة مثل التفوق الدراسي أو المشاركة الاجتماعية، يشعر الأبناء بقيمة أنفسهم.
- تكوين صورة ذاتية صحية: الثقة بالنفس المتولدة من دعم الأسرة تقي الأفراد من عقد النقص والمقارنات السلبية مع الآخرين.
2- تخفيف التوتر والضغط النفسي
- شبكة أمان عاطفية: وجود أفراد يمكن التحدث إليهم عن ضغوط العمل أو الدراسة يقلل من عبء الضغوط اليومية.
- الاستقرار الأسري: البيت المستقر عاطفيًا يوفّر بيئة مريحة للفرد، مما يعزز القدرة على مواجهة تحديات الحياة الخارجية.
- تقليل الأعراض الجسدية للتوتر: مثل الصداع، الأرق، واضطرابات المعدة، حيث أن الدعم الأسري يقلل من مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالضغط النفسي.
3- الدعم العاطفي والتفريغ النفسي
- مشاركة المشاعر: القدرة على البوح بالمخاوف، القلق، أو الحزن داخل الأسرة تمنع تراكمها وتحولها إلى اضطرابات.
- الإحساس بالانتماء: العلاقات الدافئة توفر شعورًا بأن الفرد “مفهوم ومقبول”، وهو أساس الصحة النفسية الإيجابية.
- منع العزلة: الدعم العاطفي يقلل احتمالية الانسحاب الاجتماعي الذي يرتبط بالاكتئاب.
4- تعزيز المرونة النفسية (Resilience)
- التعلم من الأزمات: الأسرة المتماسكة تساعد أفرادها على رؤية الأزمات كتجارب تعليمية لا كهزائم نهائية.
- توزيع الأدوار: عند مواجهة صعوبات (مرض، أزمة مالية) يُوزَّع العبء بين
الأثر السلبي للعلاقات الأسرية المضطربة
1- الاضطرابات النفسية
- النزاعات المستمرة، الانفصال، أو الطلاق تُحدث شرخًا عاطفيًا لدى الأبناء.
- الطفل الذي يعيش في بيئة يسودها التوتر والعداء يكون أكثر عرضة للإصابة باضطرابات القلق والاكتئاب، وقد تتطور لاحقًا إلى اضطرابات أكثر تعقيدًا مثل الوسواس القهري أو اضطراب الشخصية الحدّية.
- دراسة إقليمية بينت أن الأطفال الذين يشهدون عنفًا منزليًا تزيد احتمالية إصابتهم بالاكتئاب بنسبة 40%.
2- فقدان الهوية والارتباك القيمي
الأسر التي تتسم بالتناقض (مثل الدعوة لقيم أخلاقية مع ممارسات سلوكية مخالفة) تزرع ارتباكًا لدى الأبناء حول معايير الصواب والخطأ.
هذا يؤدي إلى صعوبة بناء هوية نفسية متماسكة، ويدفع البعض للبحث عن بدائل خارجية مثل جماعات الأقران أو الإنترنت.
فقدان الهوية يزيد خطر السلوكيات الخطرة والانحرافات الفكرية والاجتماعية.
3- ضعف تقدير الذات
- النقد المستمر، المقارنات السلبية، أو إهمال الإنجازات الصغيرة يولد لدى الفرد شعورًا بعدم الكفاءة والدونية.
- الأطفال الذين يتعرضون للنقد القاسي يميلون إلى الانسحاب الاجتماعي والخوف من خوض التجارب الجديدة، مما يحد من تطور مهاراتهم الشخصية والمهنية لاحقًا.
- ضعف تقدير الذات يرتبط أيضًا باضطرابات الأكل واضطراب القلق الاجتماعي.
4- العنف الأسري
- يشمل العنف اللفظي، الجسدي، أو النفسي. وهو من أخطر المؤثرات طويلة المدى.
- يؤدي إلى اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، أحلام مزعجة، قلق مفرط، وشعور دائم بالتهديد.
- النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للتأثر بالعنف الأسري، مما ينعكس على قدراتهم التعليمية، الاجتماعية، ومستوى الصحة النفسية العام.
- الأبحاث أظهرت أن 1 من كل 3 نساء عالميًا تعرضن لشكل من أشكال العنف الأسري (UN Women, 2021)، مع انعكاسات نفسية ممتدة حتى في مرحلة البلوغ.
5- الانعزال الاجتماعي
- غياب الدعم الأسري يولّد شعورًا عميقًا بالوحدة والإقصاء، ما قد يقود إلى العزلة المزمنة.
- العزلة الاجتماعية بدورها ترتبط بزيادة معدلات الاكتئاب والأفكار الانتحارية.
- في المراهقة، الانعزال قد يدفع الشباب للجوء إلى مجموعات افتراضية سامة أو الانغماس في العالم الرقمي كبديل للعلاقات الواقعية.
6- الإدمان بأنواعه
- غياب الاحتواء الأسري أو ضعف الروابط العاطفية يجعل الفرد أكثر عرضة لتعويض هذا النقص عبر سلوكيات إدمانية.
- قد يظهر الإدمان في شكل تعاطي المخدرات، الكحول، أو حتى الإدمان الرقمي (ألعاب الفيديو، شبكات التواصل).
- تشير دراسات إلى أن الشباب من أسر مفككة أكثر عرضة بنسبة 2.5 مرة للإدمان مقارنة بنظرائهم في أسر متماسكة.
- الإدمان هنا ليس مجرد سلوك فردي، بل محاولة للهروب من فراغ عاطفي ونفسي خلفه تفكك الأسرة.
7- انتقال الصدمات بين الأجيال
- الأثر السلبي للعلاقات الأسرية لا يتوقف عند جيل واحد؛ فالأطفال الذين نشأوا في بيئة مضطربة غالبًا ما يعيدون إنتاج نفس الأنماط في أسرهم المستقبلية.
- هذا ما يُعرف في علم النفس بـ “الصدمة العابرة للأجيال” (Transgenerational Trauma)، حيث تنتقل القيم والسلوكيات السلبية مثل العنف أو الإهمال عبر الأجيال.
أنماط العلاقات الأسرية وتأثيرها
1- العلاقات الأسرية المتماسكة
- السمات: يسودها جو من الاحترام المتبادل، والتفاهم، والانفتاح في الحوار بين أفرادها. يتيح الوالدان حرية التعبير للأبناء مع وجود ضوابط تربوية واضحة.
- الأثر النفسي: تنشئ شخصية متوازنة وواثقة من نفسها، تقل فيها معدلات القلق والاكتئاب، وتزداد القدرة على التكيف مع ضغوط الحياة.
- الأثر الاجتماعي: الأبناء في هذه الأسر غالبًا ما يتمتعون بمهارات اجتماعية قوية، ويميلون لتكوين صداقات صحية، ولديهم استعداد أكبر لبناء أسر ناجحة مستقبلًا.
2- العلاقات الأسرية المتسلطة
السمات: تعتمد على القمع، فرض الرأي، والانضباط الصارم، حيث يغيب الاستماع إلى الأبناء وتُفرض القواعد دون نقاش.
الأثر النفسي: يولّد لدى الأبناء شعورًا دائمًا بالضغط والخوف من الفشل، مما قد يؤدي إلى القلق، ضعف الثقة بالنفس، أو في بعض الحالات إلى التمرد والعصيان.
الأثر الاجتماعي: أبناء هذه الأسر إما أن يصبحوا أشخاصًا خاضعين وغير قادرين على اتخاذ قرارات مستقلة، أو يميلون إلى السلوك العدواني والعزلة.
3- العلاقات الأسرية المهملة
- السمات: يغيب فيها الحنان والاهتمام، حيث لا يلبي الوالدان الاحتياجات العاطفية أو التربوية للأبناء. أحيانًا ينشغل الأهل بالعمل أو بمشكلاتهم الخاصة.
- الأثر النفسي: يؤدي هذا النمط إلى فراغ عاطفي، شعور بالوحدة، وتدني احترام الذات. بعض الأبناء قد يبحثون عن الاهتمام في أماكن غير صحية (مثل العلاقات السامة أو الإدمان).
- الأثر الاجتماعي: ضعف في الانتماء الأسري، ميل للانطواء أو الاعتماد المفرط على الآخرين، مع صعوبة بناء علاقات طويلة المدى قائمة على الثقة.
4- العلاقات الأسرية المتناقضة
- السمات: تتسم بالتقلب، حيث يعيش الأبناء مزيجًا من الحب والدعم في لحظات معينة، والصراع والتوتر في لحظات أخرى. قد يكون أحد الوالدين حنونًا بينما الآخر صارمًا أو غائبًا.
- الأثر النفسي: هذا التناقض يخلق حالة من عدم الأمان الداخلي، حيث لا يعرف الأبناء ماذا يتوقعون. غالبًا ما يتولد القلق المزمن، صعوبة تنظيم العواطف، وربما الميل لاضطرابات الشخصية.
- الأثر الاجتماعي: هؤلاء الأبناء قد يصبحون مترددين في العلاقات المستقبلية، غير قادرين على الثقة بالآخرين، أو يميلون لتكرار نفس نمط التناقض في علاقاتهم الزوجية والاجتماعية.
العوامل المؤثرة في جودة العلاقات الأسرية
1- الوضع الاقتصادي
- الأثر المباشر: الضغوط المالية المستمرة مثل البطالة، الديون، أو انخفاض الدخل، كثيرًا ما تتحول إلى توتر وصراعات زوجية، وتُشعر الأبناء بعدم الأمان.
- الأثر النفسي: يولّد شعورًا بالقلق المزمن لدى الوالدين، وقد يُترجم إلى عصبية زائدة أو إهمال للاحتياجات العاطفية للأبناء. أما الأبناء فقد يشعرون بالحرمان مقارنة بأقرانهم، مما يؤدي إلى الإحباط أو الانسحاب الاجتماعي.
- الأثر الاجتماعي: قد تدفع الضغوط الاقتصادية بعض الأسر إلى اللجوء للعمل المفرط، أو الهجرة، أو حتى انهيار الأسرة عبر الطلاق أو التفكك.
2- التعليم والوعي
االأسر المتعلمة: غالبًا ما تكون أكثر قدرة على إدراك أهمية الحوار، المرونة في التربية، ورعاية الصحة النفسية لأفرادها.
الأسر الأقل وعيًا: قد تعتمد على أساليب تربوية تقليدية أو صارمة، مما يعزز الفجوة بين الأجيال.
الأثر النفسي: التعليم يُمكّن الوالدين من توفير بيئة غنية بالتحفيز والتشجيع، مما ينعكس إيجابًا على ثقة الأبناء بأنفسهم وعلى تطورهم العقلي.
الأثر الاجتماعي: ارتفاع مستوى التعليم يعزز مكانة الأسرة في المجتمع، ويزيد من فرص الترابط الأسري عبر نقاشات واعية وقرارات مشتركة.
3- القيم الثقافية والدينية
- الدور البنائي: تحدد الثقافة والدين أدوار أفراد الأسرة، أسس الاحترام المتبادل، والالتزام بالمسؤوليات. مثلًا، المجتمعات المحافظة تميل إلى إبقاء الروابط الأسرية قوية ومتشابكة.
- الأثر النفسي: القيم الدينية والثقافية قد تمنح شعورًا بالانتماء والدعم الروحي، مما يحمي من الاكتئاب والاضطرابات النفسية.
- الأثر السلبي المحتمل: في حال كانت القيم جامدة أو متطرفة، قد تقيّد حرية الأفراد وتخلق صراعات داخلية بين رغباتهم الشخصية والتوقعات الاجتماعية.
4- التواصل داخل الأسرة
- الأثر المباشر: غياب الحوار والإنصات يحوّل الأسرة إلى بيئة صامتة مليئة بالفجوات العاطفية، حيث يشعر كل فرد بالعزلة حتى وهو داخل البيت.
- الأثر النفسي: ضعف التواصل يؤدي إلى تراكم المشاعر السلبية، مثل الغضب أو الإحباط، والتي قد تنفجر لاحقًا في شكل نزاعات حادة.
- الأثر الإيجابي: وجود تواصل فعّال مبني على الاستماع والتعبير يخلق مناخًا من الثقة، ويقوّي الروابط، ويمنع الانجراف نحو الانعزال أو السلوكيات السلبية.
5- الضغوط الاجتماعية
- البطالة: تضعف الشعور بالقيمة لدى المعيل، وتنعكس على ثقة الأبناء بمستقبلهم.
- الهجرة: قد تؤدي إلى انفصال الوالدين عن الأبناء لفترات طويلة، مما يخلق فجوات في الرعاية والاحتواء.
- الحروب والأزمات: تفقد الأسرة إحساسها بالاستقرار والأمان، وتُدخلها في دوامة من الصدمات النفسية مثل القلق الحاد واضطراب ما بعد الصدمة.
- الأثر الاجتماعي العام: هذه الضغوط تجعل الأسرة أكثر عرضة للتفكك أو الانغلاق على ذاتها، بدلًا من الانفتاح وبناء علاقات صحية مع المجتمع.
الاستراتيجيات لتعزيز العلاقات الأسرية الصحية
1- الحوار الفعّال
- المعنى: التحول من لغة الأوامر والنقد المستمر إلى أسلوب قائم على النقاش الهادئ والاحترام المتبادل.
- الآلية: منح كل فرد مساحة للتعبير عن رأيه دون مقاطعة، مع الاستماع بتركيز.
- الأثر النفسي: يقلل من التوتر ويعزز الشعور بالتقدير والاعتراف بالذات.
- أمثلة عملية: تخصيص وقت أسبوعي لجلسة عائلية لمناقشة القضايا اليومية أو القرارات المهمة.
2- التعبير عن المشاعر
المعنى: تشجيع أفراد الأسرة على مشاركة عواطفهم سواء كانت إيجابية (فرح، امتنان) أو سلبية (حزن، غضب).
الآلية: استخدام عبارات “أنا أشعر بـ…” بدلًا من “أنت دائمًا…”، لتجنب اللوم.
الأثر النفسي: يقلل من الكبت الانفعالي الذي قد يتحول إلى اكتئاب أو قلق.
أمثلة عملية: قيام الأبوين بمشاركة أبنائهم بمشاعرهم اليومية، مما يفتح المجال أمام الأبناء للتقليد.
3- تقاسم المسؤوليات
- المعنى: توزيع المهام المنزلية والأعباء المعيشية بعدالة بين جميع الأفراد بحسب قدراتهم.
- الآلية: وضع جدول مرن للأعمال المنزلية بحيث يشارك فيه الأبناء أيضًا.
- الأثر النفسي: يقلل من الإحساس بالظلم أو الاستغلال، ويعزز التعاون وروح الفريق.
- أمثلة عملية: أن يشارك الأبناء في تنظيف البيت أو الطهي مع الأبوين، بدلًا من ترك العبء كاملًا على الأم أو الأب.
4- الأنشطة المشتركة
- المعنى: القيام بأنشطة عائلية ترفيهية أو تعليمية تزيد من الترابط.
- الآلية: اختيار نشاط يرضي الجميع مثل الرياضة، مشاهدة فيلم، الطهي الجماعي، أو السفر.
- الأثر النفسي: تقوية الروابط العاطفية وإعادة شحن الطاقة الإيجابية داخل الأسرة.
- أمثلة عملية: تنظيم “ليلة عائلية” أسبوعية دون هواتف أو إنترنت للتركيز على التفاعل المباشر.
5- التثقيف النفسي الأسري
- المعنى: رفع وعي الوالدين بطرق التربية الحديثة وأثرها على الصحة النفسية للأبناء.
- الآلية: قراءة كتب، حضور دورات تدريبية، أو متابعة محتوى متخصص في التربية والصحة النفسية.
- الأثر النفسي: يمنح الأهل أدوات عملية لحل المشكلات بطرق بناءة، ويقي الأبناء من الأخطاء التربوية الشائعة.
- أمثلة عملية: تعلم استراتيجيات مثل “التربية الإيجابية” أو “إدارة الغضب عند الأطفال”.
6- الاستشارات الأسرية
- المعنى: طلب المساعدة من مختصين نفسيين أو اجتماعيين عند تفاقم الخلافات أو ظهور اضطرابات سلوكية.
- الآلية: حضور جلسات علاج أسري تهدف إلى تحسين التواصل وفهم الاحتياجات النفسية لكل فرد.
- الأثر النفسي: يفتح مجالًا للحوار بإشراف مختص، ويمنع تراكم المشكلات حتى تصل إلى الطلاق أو العنف الأسري.
- أمثلة عملية: اللجوء لمعالج أسري عند تكرار الخلافات الزوجية أو عند ملاحظة علامات اكتئاب أو إدمان على أحد الأبناء.
7- تعزيز الدعم الاقتصادي
- المعنى: ضمان الحد الأدنى من الاستقرار المالي للأسر لتقليل الضغوط النفسية.
- الآلية: عبر سياسات حكومية مثل دعم الأسر الفقيرة، توفير تأمين صحي، أو برامج تدريب وتشغيل للشباب.
- الأثر النفسي: تقليل الضغوط الناتجة عن القلق المادي، مما يتيح للأسر التركيز على الجانب العاطفي والعلاقات.
- أمثلة عملية: برامج مثل “دعم الخبز” أو “الحماية الاجتماعية” في الأردن ومثيلاتها في الدول العربية التي تساعد الأسر على تجاوز الأزمات الاقتصادية.
الخاتمة
العلاقات الأسرية ليست مجرد تفاصيل يومية في حياة الأفراد، بل هي المحرك الأساسي لصحتهم النفسية وسلوكهم الاجتماعي. فكل علاقة داعمة تعزز قدرة الفرد على مواجهة العالم، وكل علاقة مضطربة تُعمّق الجراح النفسية. إن بناء أسر متوازنة يتطلب وعيًا، تربية إيجابية، وحوارًا دائمًا، لأن الاستثمار في الأسرة هو في الحقيقة استثمار في صحة المجتمع بأكمله.
ماذا يقدم موقع سيكولوجي بالعربي؟
يقدم علاج رسمي لجميع الاضطرابات النفسية او الامراض النفسية بأيدي مستشارين الموقع المختصين